تقرير المرصد العمالي الأردني بمناسبة عيد العمال
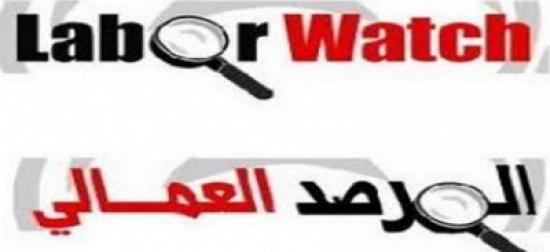
المديننة نيوز -: أصدر المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، تقرير تحت عنوان " الحق في العمل 2013 "، بمناسبة يوم العمال.
نص التقرير :
يأتي هذا التقرير في سياق التقارير الشاملة والمقتضبة التي يصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وفي اطار برنامج المرصد العمالي الأردني، وهذا التقرير هو الرابع من نوعه والذي نقدم خلاله صورة بانوراميه لحالة العمل في الأردن بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف في الأول من أيار من كل عام. وهذا اليوم العالمي للعمل يجسد ذكرى النضالات العمالية في كافة أنحاء العالم، ويمثل روح العمل الإنساني والعمالي الجماعي للدفاع عن حقوق العمال على اختلاف مهنهم ووظائفهم واجناسهم وجنسياتهم وأصولهم وأماكن عملهم. ويأتي كذلك إحياءً لذكرى الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتحديد ساعات العمل بثمان ساعات في اليوم، وهو من جهة يشكل مناسبة عالمية للوقوف على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحركة العمالية العالمية، ومن جهة أخرى للوقوف على التحديات التي تواجه العاملين بأجر في مختلف أنحاء العالم.
ويتوقف مئات الملايين من العمال في مختلف أنحاء العالم الذين ما زال غالبيتهم يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات التي تمس حقوقهم الأساسية سواء كان ذلك في مستويات الأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من شروط العمل.
وهنا في الأردن ورغم كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل لتحسين شروط العمل سواء كان على مستوى التشريعات والسياسات التي تنظم ظروف العمل، أو على مستوى تطبيق هذه التشريعات والسياسات، إلا أن هنالك العديد من المؤشرات تظهر وبوضوح أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة من حيث تدني معدلات اجورهم، ومعدلات البطالة المرتفعة خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية. ويعود ذلك الى ضعف تشريعات وسياسات العمل الأردنية وعدم موائمتها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية الى جانب ضعف تطبيق هذه التشريعات والسياسات رغم ضعفها.
وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة والأردن يواجه العاملين في الاردن تحديات كبيرة ومضاعفة خاصة في ظل اغراق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العمالة الوافدة (المهاجرة) الأمر خلق حالة من المنافسة غير العادلة في سوق العمل، وشكل هذا مؤشرا على ضعف الادارة العامة الأردنية على ضبط سوق العمل وتنظيمه، لا بل عدم قدرتها على تنظيمه هذا من جانب ومن جانب آخر تفشي الممارسات غير القانونية في عمل العديد من المؤسسات الرسمية في هذا المجال، وتفاقمت هذه المشكلة بعد دخول عشرات الآلاف من اللاجئين السوري مضطرين الى سوق العمل لكسب رزقهم.
وفي هذا التقرير سيتم الوقوف عند السياسات العامة الناظمة للحق في العمل في الأردن، وعند مستويين، الأول يتمثل في قراءة للحق في العمل في التشريعات الأردنية على اختلاف مستوياتها، الى جانب تقديم قراءة مقتضبة لواقع تمتع العاملين في الأردن بالحدود الدنيا لمعايير العمل الدولية باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية لحقوق الانسان.
السياسات العامة الناظمة للحق في العمل
يعد الحق في العمل من الحقوق الإنسانية الأساسية التي اقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويقتضي ذلك التزام الدولة الأردنية باحترام وحماية وكفالة امكانية قيام كل شخص بعمل لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله، خاصة وأن الأردن ملزم اخلاقيا وقانونيا بتمكين الأردنيين من التمتع بهذا الحق لأنه صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 1976 ونشره في الجريدة الرسمية عام 2006، واصبح بذلك جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية ويسمو على التشريعات الوطنية التي تتعارض معه.
وفي هذا السياق وعلى مستوى التشريعيات تضمن الدستور الأردني نصوصاً تكفل الحق في العمل لجميع المواطنين الا أنه وللأسف ربط توفير هذا الحق بإمكانات الدولة، وهي الفجوة التي تتهرب من خلالها مختلف الحكومات على تمكين المواطنين من التمتع بهذا الحق، وأكد الدستور على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، وأن الدولة تحمي العمل وتضع له تشريعاً يقوم على مجموعة من المبادئ تتمثل في اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته وتحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر، وتعويض خاص للعمال المعيلين والعمال في احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل وتعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث وخضوع المعامل للقواعد الصحية وتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
وفي هذا السياق ما زالت التشريعات الأردنية وخاصة قانون العمل الأردني المعمول به حاليا، قاصراً عن انفاذ العديد من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، ولعل ابرزها غياب حق وحرية التنظيم النقابي للعاملين. فما زالت نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بحق وحرية التنظيم النقابي تتعارض مع الحقوق الأساسية التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وما زالت الحكومة لم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وانعكس ذلك بشكل رئيسي على منع العاملين بأجر في الأردن من تنظيم انفسهم بنقابات بحرية، إذ تحظر الحكومة تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية الرسمية ال (17)، والتي لم يزد عددها منذ ما يقارب اربعة عقود. الأمر الذي دفع عشرات الآلاف من العاملين بأجر في الأردن في القطاعين العام والخاص الى تنظيم انفسهم بنقابات مستقلة دون الحصول على موافقات من الحكومة، خاصة بعد أن تراجعت وبشكل ملموس شروط عملهم، وفشل النقابات العمالية القائمة في الدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم.
ومن الجدير بالذكر أن الأردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالرغم من عدم مصادقته عليها، لأنها أحدى ثمان اتفاقيات مكونة لإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي أقر في عام 1998، والزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأردن واحدة منها. وقد تم تقييد حق التنظيم النقابي بأحكام خاصة في القانون من خلال نصه على أن "للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية " . وتبعه نص آخر يقيد هذا الحق من خلال منح صلاحية تصنيف المهن التي يحق لها تأسيس نقابات دون غيرها الى جانب المهن التي لا يحق لها تأسيس نقابات الى لجنة ثلاثية مكونة من الحكومة ونقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
والى جانب مصادقة الأردن على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد صادق على (24) اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، إلاّ أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تنشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية، حيث اكتفت بنشر (13) اتفاقية فقط بهدف تأجيل تطبيق معايير العمل التي تتضمنها، لأن الاتفاقيات غير المنشورة في الجريدة الرسمية غير ملزمة للحكومة حسب المنظومة التشريعية الأردنية. الأمر الذي انعكس على أحكام قانون العمل الأردني من حيث عدم تضمينه العديد من التزامات ومضامين الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها، بل اكتفت بإيراد البعض منها دون الآخر وبطريقة انتقائية. وفي هذا السياق صادق الأردن على7 اتفاقيات من أصل الاتفاقيات الثمانية الأساسية الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أصدرته منظمة العمل الدولية في عام 1998.
وفي هذا السياق لم يصادق الأردن حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم لسنة 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ في العالم في تموز 2003. ومن الجدير بالذكر هنا أن قانون العمل الأردني لا يفرق بين العمالة الوطنية والمهاجرة (الوافدة) في غالبية الحقوق العمالية الأساسية، الا أنه حرمهم من حق تأسيس النقابات العمالية والترشح لإدارتها، واستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقد انعكست مجمل السياسات الأردنية المتعلقة بالعمل على مستويات التمتع بمعايير الحق بالعمل. إذ يعد الأردن من أقل الدول في العالم من حيث المؤشرات الرئيسية لسوق العمل إذ أن معدل المشاركة الاقتصادية منخفض جدا ولا يتجاوز (38%) من مجمل السكان الذين تزيد أعمارهم عن (15) عاما، فيما بلغت في ذات العام في الدول العربية بالمتوسط (46%)، و في دول الاتحاد الأوروبي (50%). ويرافق ذلك انخفاض شديد في انفاق الدولة الأردنية على الحق في العمل إذ يبلغ بالمتوسط (2%) خلال السنوات (2000-2010).
توفر فرص العمل
في مجال الحق بالحصول على عمل، ما زالت معدلات البطالة في الأردن مرتفعة، حيث تبلغ (12.8%)، في الربع الأول من العام الجاري 2013، يتركز غالبيتهم في الفئات الشبابية وخاصة بين الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغت 36.1% و30.1% لكل منهما على التوالي. كذلك أشارت الأرقام أن معدلات البطالة عند الإناث تزيد عنها عند الذكور، ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة عند الذكور (11.1%) بلغ عند الإناث (20.5%). وغالبية المتعطلين عن العمل هم من الخريجين الجدد ومن الأشخاص الذين يقل تأهيلهم العلمي عن الثانوية العامة، وفي هذا الاطار تعد خطوة الحكومة الأردنية في تطوير واطلاق استراتيجية تشغيل شاملة خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن الخطوة التي لا تقل أهمية عن ذلك، هو تطبيق هذه الاستراتيجية، فالكثير من خطط وسياسات العمل التي تم تطويرها سابقا، لم نلمس لها أي أثر حقيقي وملموس على أرض الواقع. والخلاصة لم يتمكن الاقتصاد الأردني خلال العقدين الماضيين من توفير فرص عمل كافية للمواطنين، وما زال قاصرا عن توفير هذا الحق لهم. فقد قامت الحكومات المتعاقبة بتطبيق نموذج تنموي خلال تلك الفترة ركزت فيها على المشاريع الضخمة وخاصة العقارية والتي تولد فرص عمل مؤقتة وغير كثيفة وغالبيتها يذهب الى العمالة المهاجرة، وعلى النمو دون النظر الى تأثير ذلك على توفير فرص عمل لائقة. كذلك لم تتمكن الحكومات الأردنية المتعاقبة من الربط بين سياسات التعليم المهني والفني وبين حاجات ومتطلبات سوق العمل الأردني.
الأجور
وفيما يتعلق بمستويات الأجور فإن الغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في الأردن لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي، وهنالك فجوة كبيرة بين معدلات الاجور التي يحصل عليها الغالبية الساحقة من الأردنيين وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم. فحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هنالك تدن واضح في معدلات الأجور لغالبية العاملين بأجر، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، الأمر الذي أدى الى اتساع رقعة العمالة الفقيرة، فحسب ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن متوسط الأجر الشهري في عام 2011 بلغ (412) دينارا ، وتؤكد ذلك أرقام دائرة الاحصاءآت العامة.
وعند مقارنة هذه الأرقام بمستويات الفقر في الأردن نلحظ المستوى المتدني لمعدلات الأجور هذه، فالأرقام الأولية لدراسة الفقر للعام 2010 التي اجرتها دائرة الإحصاءات العامة أشارت الى أن الأسرة المعيارية المكونة من ستة أفراد (5.4) يقترب خط الفقر المطلق لها من (350) دينارا شهريا. وهنالك أرقام جديدة صادرة عن دائرة الاحصاءآت العامة لم تنشر تفاصيلها بعد تشير الى ان حد الفقر للفرد سنويا يبلغ 400 دينار سنويا، وبحسبة بسيطة يتبين أن خط الفقر للأسرة المعيارية شهريا يبلغ 380 دينارا، وعند التعمق في شرائح الأجور التي يحصل عليها العاملون بأجر في الأردن، نلحظ الوضع الكارثي، إذ نجد أن (22. بالمائة منهم تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينارا فأقل، و (46.1) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (300) ديناراً فأقل، وكذلك (72.1) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (400) دينارا فأقل. وكذلك الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي يبلغ (190) دينارا شهريا، وهو يقل عن نصف خط الفقر المطلق والصادر عن قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل كبير وملفت. وهنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر في الأردن ( عمالة وطنية ووافدة) يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، ويشكل انخفاض الأجور السبب الأساسي لغالبية الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال الاعوام الماضية.
الحماية الاجتماعية
وفي جانب حق الحماية الاجتماعية، فإن قانون الضمان الاجتماعي الأردني يوفر مجموعة من التأمينات الاجتماعية تشمل اعانات تخص اصابات العمل والعجز والشيخوخة والورثة وحماية الأمومة، ولا يشمل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة. وعلى الرغم من التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي والتي كانت غالبيتها تعديلات ذات صبغة إصلاحية، بحيث تشمل جميع القوى العاملة في الأردن قانونياً، ولا تفرق بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة (المهاجرة) باستثناء عاملات المنازل، فإن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي مازالت قليلة، فهم يشكلون (56%) من مجمل القوى العاملة (مشتغلين وغير مشتغلين)، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) في نهاية عام 2012 ما يقارب مليون منتفع. هذا الى جانب أن منظومة التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا زالت غير شاملة وفق المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، فالتأمين الصحي ما زال خارج هذه المنظومة، والتأمين ضد البطالة تم استبداله بالتأمين ضد التعطل عن العمل وينتابه القصور. وما زالت آليات احتساب الرواتب التقاعدية غير عادلة ولا توفر مستويات معيشية لائقة لغالبية المتقاعدين.
وبالمجمل فإن قانون الضمان الاجتماعي لا يحقق المعايير الدولية الدنيا للحماية الاجتماعية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية والتي غطت مختلف التأمينات الاجتماعية وتمثلت في خمس اتفاقيات لم يصادق الأردن على أي منها حتى الآن. وما زال قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن لا يقدم تسهيلات للعاملين في القطاع غير المنظم في الأردن للاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي، والمدخل الوحيد لتغطيتهم تكون من قواعد الاشتراك الاختياري التي يدفع فيها العامل حصته وحصة صاحب العمل الى صندوق الضمان. ويجري الان مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اقراره قبل نهاية هذا العام 2013.
وفي هذا السياق تتفاوت مستويات تمتع العاملين بالتأمينات الاجتماعية، فهناك التأمينات الاجتماعية التي يوفرها نظام التقاعد المدني والعسكري للعاملين في القطاع العام، وهنالك أنظمة التقاعد الأخرى التي يتمتع بها المهنيون من خلال نقاباتهم المهنية. وتقدم هذه النظم جملة من التأمينات الاجتماعية وبشكل متفاوت بين نقابة مهنية وأخرى مثل إعانة الشيخوخة (الراتب التقاعدي) وإعانات الورثة والعجز والتأمين الصحي. ووفق أقل التقديرات المتداولة في الأردن فإن ما يقارب (350) ألف عامل في الأردن واسرهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين الصحي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
حرية التنظيم النقابي
وفيما يتعلق بالحق وحرية التنظيم النقابي، فإن العاملين في الأردن محرومون وفق نصوص القانون كما تم الاشارة اليه سابقاً من هذا الحق، واقتصر القانون على السماح بتأسيس نقابات عمالية محدودة يبلغ عددها (17) نقابة، والذي دفع قطاعات واسعة من العاملين المحرومين من التنظيم النقابي الى تنظيم انفسهم في تجمعات وهيئات خارج إطار الهيئات النقابية المعترف بها رسميا. ولدينا في الأردن في الوقت الحالي (10) نقابات عمالية مستقلة ، شكلت فيما بينها اتحادا عماليا مستقلا قبل ايام، الى جانب العديد من اللجان النقابية المستقلة في العديد من مواقع العمل وقطاعاته. وقد كان للسياسات الحكومية التمييزية ضد العاملين والتي سمحت لأصحاب العمل من ممارسة حقهم في تشكيل منظماتهم بكل حرية لدرجة أنه يوجد في الأردن حاليا ما يقارب 85 منظمة اصحاب عمل، بينما حرمت العاملين بأجر من هذا الحق، الأمر الذي خلق حالة من الاختلال بين طرفي علاقات العمل، حيث هنالك أصحاب عمل منظمين بشكل جيد يسمح لهم بتنظيم مصالحهم والدفاع عنها، وعاملين غير منظمين وغير قادرين على الدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم، الا أن انفجر الوضع مؤخرا وعبر عن نفسه بمئات الاضرابات العمالية خلال لفترة قصيرة.
المفاوضة الجماعية
وفيما يتعلق بحق المفاوضة الجماعية، ورغم أن الأردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، الا أن النصوص القانونية والتعليمات المتبعة في ذلك اوجدت حالة من عدم سلاسة واستقلالية آليات المفاوضة الجماعية، ويعطي القانون الحق للحكومة بالتدخل في أي مرحلة من مراحل التفاوض، الأمر الذي يضعف دور النقابيين ويجردهم من أدواتهم الضاغطة والتي يعد الاضراب أهمها. ولذلك فإن جميع الاضرابات العمالية التي تم تنفيذها في الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة تم تصنيفها بأنها اضرابات غير قانونية حسب نصوص قانون العمل.
وفي هذا المجال يحرم قانون العمل الأردني العاملين الذين ليس لديهم تنظيم نقابي، أو لديهم تمثيل نقابي ضعيف من حق المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل، واقتصرها على النقابات المعترف بها من قبل الحكومة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاعات العمالية غير المشمولة بالتنظيم النقابي بعدم قدرتها على التفاوض مع أصحاب العمل وتحسين شروط عملها إلى جانب ذلك فإن قانون العمل يحد من استقلالية النقابات العمالية من خلال منح وزير العمل الحق في حل النقابة إذا رأى الوزير أن النقابة ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو إذا تضمن النظام الداخلي مخالفة للتشريعات النافذة. وعلى الرغم من كل هذه القيود، فإن الأردن شهد خلال العامين 2011 و 2012 حراكا عماليا ونقابيا غير مسبوق عبر عن نفسه بأكثر من (829) و (901) احتجاجاً عمالياً غالبيتها الساحقة تم تنفيذها من مجموعات عمالية مستقلة غير معترف بها رسميا.
وتعددت الأسباب التي دفعت العاملين للاحتجاجات وشملت المطالبة بزيادة الأجور والاعتراض على الفصل من العمل والمطالبة بالتثبيت وتحسين المنافع والحوافز والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة ومحاربة الفساد داخل اتحاد نقابات عمال الأردن، إلى جانب أسباب أخرى تتمثل بتحسين شروط العمل بشكل عام، وكانت غالبية الاحتجاجات تتركز على زيادة الاجور والمنافع التعويضية. وتؤشر الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات واسعة من العاملين في الأردن في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة في أسعار السلع والخدمات الاساسية. والتي نجمت بشكل رئيسي عن سياسات التحرير الاقتصادي التي طبقتها الحكومات الأردنية المتعاقبة والتي أدت الى ارتفاعات عالية في الأسعار وثبات نسبي في معدلات الأجور.
المرأة في سوق العمل
ما زالت الأرقام الرسمية تشير أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية عام 2012 ( قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14.1 بالمائة مقارنة مع 60.6 بالمائة عند الذكور، وهذه النسبة تراوح مكانها منذ سنوات، لا بل تراجعت عن ما كانت عليه في عام 2012، إذ كانت تبلغ 14.9 بالمائة. وهي منخفضة جدا إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 30 بالمائة، وفي معدل المشاركة الاقتصادية على المستوى العالمي الذي يبلغ 50 بالمائة في عام 2012، الأمر الذي يشير الى عدم فعالية الجهود التي تبذل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. ومن المفيد الاشارة هنا الى أن ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي لعام 2010 في مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادي كان الأخير بين (139) دولة.
ويعود ذلك بشكل أساسي الى جملة من العوامل تساهم في تخفيض معدلات مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، فمن جانب هنالك ظروف العمل غير اللائقة التي يعاني منها سوق العمل الأردني بشكل عام، وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة والقطاع غير المنظم، وهي تعتبر بيئة غير صديقة وطاردة للنساء الراغبات بالعمل، ولا تشجعهن على الالتحاق به أو الاستمرار فيه. ومنها كذلك أن المرأة تواجه تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في سوق العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً على دخولهن إلى سوق العمل، ولا تأخذ فرصا متساوية في تقلد المناصب العليا والترقية وفي الحصول على فرص التدريب داخل وخارج الأردن.
من جانب آخر فإن أحدث الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتعلقة بعام 2012 تشير إلى أن نسبة النساء المشتركات في المؤسسة تقارب 25.0 بالمائة من مجمل المشتركين في المؤسسة . هذا وما زالت معدلات البطالة عند النساء الأردنيات أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 20.5 بالمائة مقابل 11.1 بالمائة عند الرجال في الربع الأول من عام 2013 . وهي تزيد كثيرا عن معدل البطالة عند النساء على المستوى العالمي في عام 2012 والتي تبلغ (6.4%). وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام (الحكومي) تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع، وتشكل نصف القوى العاملة النسائية. فإن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية. وتتركز الغالبية الساحقة من النساء العاملات في الأردن في ثلاثة قطاعات اقتصادية من أصل (13) اقتصادي، وهذه القطاعات الثلاثة تتمثل في الادارة العامة والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، بنسبته (95) بالمائة من النساء العاملات.
وتشير كذلك العديد من التقارير العمالية والحقوقية أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص يتعرضن للعديد من الانتهاكات وتجاوزات مخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وغيرها من شروط العمل اللائق، فما زالت فجوة الأجور لصالح الذكور مرتفعة وتبلغ ( 63) دينارا في القطاع العام و (69) دينارا شهريا في القطاع الخاص.
وإذا ما علمنا أن النساء في الأردن يشكلن ما نسبته 51 بالمائة من طلبة البكالوريوس في مختلف الجامعات حسب أرقام 2012، فإن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فهي من جانب تحرم طاقات إنتاجية كبيرة من المساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، ومن جانب آخر تزيد من نسبة الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن أربعة آخرين، وهذه النسبة تعد أيضاً من أعلى النسب في العالم. ويمكن القول ان عدم حدوث تقدم ملموس في دور المرأة اقتصادياً من خلال زيادة مشاركتها في جهود التنمية يعود بشكل أساسي الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها سوق العمل الأردني ويعاني منها كل من الرجال والنساء.
العمالة الوافدة (المهاجرة)
يعاني سوق العمل الأردني ومنذ سنوات من حالة فوضى كبيرة في سوق العمالة الوافدة (المهاجرة)، حيث يتواجد فيه مئات الآلاف من العمالة الوافدة (المهاجرة) غير المسجلة لدى السلطات الحكومية. وتقدر الحكومة أعداد العمالة الوافدة غير المسجلة لديها بحوالي (800) الف عامل غالبيتهم الساحقة من المصريين، الى جانب (267) الف عامل مسجلين. وفيما يتعلق بالعاملين السوريين الذين دخلوا سوق العمل الأردن كنتائج للظروف الامنية الصعبة التي يواجهها بلدهم منذ عامين فلا يوجد اعدادا دقيقة لهم، الا ان التقديرات تشير الى ان اعدادهم تتراوح ما بين (40 -50) الفا ، غالبيتهم يعملون في القطاعات غير المنظمة وفي قطاعات الإنشاءات والزراعة ومطاعم، ويمكن الاشارة الى ان العاملين المصريين كانوا المتضررين الأساسيين من دخول العمالة السورية الى الاردن. اذ تشير التقييمات الاولية أن غالبية الوظائف التي حصلوا عليها كان يعمل فيها عمال وافدين آخرين وعلى وجه الخصوص من الجنسية المصرية.
وهذه الفوضى ناجمة عن ضعف الادارة العامة الأردنية على ضبط سوق العمل وتنظيمه لا بل عدم قدرتها على تنظيمه ومن جانب آخر تفشي الممارسات غير القانونية في عمل العديد من المؤسسات الرسمية في هذا المجال. وتفاقمت هذه المشكلة بعد دخول عشرات الآلاف من اللاجئين السوري مضطرين الى سوق العمل لكسب رزقهم. وأدى ذلك الى تفاقم حالات الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين الأردنيين والوافدين على حد سواء، فمن جانب يواجه العامل الأردني حالة من المنافسة غير العادلة في سوق العمل من حيث الأجور، وبالتالي ضعفت فرص حصول العاملين على وظائف بشروط عمل لائقة من حيث الاجور وغيرها من شروط العمل، وبالتالي القبول بشروط عمل غير لائقة، وعرضت العاملين الوافدين انفسهم لحالات استغلال والقبول بشروط عمل غير انسانية.
هذا الى جانب تعرض أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملات في المنازل، للعديد من الانتهاكات منها الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة والحرمان من الاجازات وغيرها، ونفذ العاملون والعاملات في المناطق الصناعية المؤهلة عشرات الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام الثلاث الماضية احتجاجا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها. كذلك فإن المتتبع لمسار تطور تجربة المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، يجد أن حجم الفائدة التي جناها الأردن متواضعة للغاية، لا بل فقد من رصيده المعنوي والإنساني الكثير، فقد تعرض خلال السنوات الماضية وما زال يتعرض للعديد من الانتقادات الشديدة من قبل مختلف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العاملين فيها أردنيين وأجانب. يقابل ذلك تتمتع الشركات العاملة في هذا القطاع بالعديد من الامتيازات والتسهيلات، فهي تتمتع بالإعفاءات من رسوم التصدير، وإعفاءات من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبة 75 بالمائة ولمدة 10 سنوات من تاريخ بدء إنتاج المصنع. وتتمتع مشترياتها المحلية من الضريبة العامة على المبيعات. هذا إلى جانب الاعفاءآت من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وغيرها من الامتيازات المتعلقة بمساحة البناء المسموح به في هذه المناطق. وإذ أخذ بعين الاعتبار أن فرص العمل التي خلقتها هذه المصانع للأردنيين متواضعة للغاية، تقارب (8000) عامل يعملون في ظروف صعبة جدا، وأن مدخلات الإنتاج فيها ليست أردنية، نلحظ حجم الضرر الذي جناه الأردن من هذه التجربة.
تشغيل الاشخاص من ذوي الاعاقة
على الرغم من مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، إلى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين. والتعديلات الايجابية التي شهدتها التشريعات ذات العلاقة بتشغيل الاشخاص من ذوي الاعاقة، إذ نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 وقانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته على ضرورة تشغيل المعوقين بنسبة لا تقل عن 4 بالمائة من مجمل العاملين للمؤسسات التي يعمل فيها 50 موظف فأكثر. فمستويات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقات في القطاعين العام والخاص متدنية جدا، وإن كانت معدلات تشغيل الأشخاص المعوقين في القطاع الحكومي أعلى منها في القطاع الخاص، إذ تقارب نسبة تشغيلهم في القطاع العام سواء كانت وزارات أو مؤسسات مستقلة أو بلديات أو جامعات رسمية ما نسبة 1 بالمائة في أحسن الأحوال، أما في القطاع الخاص فمستوى تشغيل الأشخاص المعوقين يكاد لا يذكر، وهي أقل بكثير مما نصت عليه القوانين الأردنية. ويواجه الأشخاص المعوقون العديد من المشكلات والمعوقات للالتحاق بسوق العمل. كذلك فإن المشتغلين من الأشخاص المعوقين يعانون من عدم حصولهم على وظائف تتلاءم وطبيعة إعاقاتهم ومنها طول ساعات العمل وانخفاض الأجور التي يتقاضونها بحجة انخفاض إنتاجيتهم وعدم توفر التسهيلات البيئية التي تتلاءم وظروف حركتهم مثل الطرق ودورات المياه الخاصة وغيرها في أماكم العمل. والى جانب ذلك يعاني العديد منهم من عدم الاعتراف بقدراتهم المهنية والاتجاهات السلبية لدى العديد من أصحاب العمل نحو تشغيل الأشخاص المعوقين والتخوف من الأعباء المالية لمتطلبات البيئة المناسبة لعملهم.
عمالة الاطفال
وفي مجال عمالة الأطفال فإن نصوص قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته تتواءم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، إذ يحظر تشغيل الأطفال والأحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، وحظر تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، وقد تم تطوير استراتيجية وطنية للحد من عمالة الأطفال في عام 2006.، الا أن أي قراءة متأنية وموضوعية لمكونات سوق العمل الأردني كافية لوضع علامة استفهام كبيرة بخصوص الأرقام المتداولة حول حجم عمالة الأطفال في الأردن. فلم يعد الرقم الرسمي المتداول والناتج عن دراسة مسحية تم تطبيقها قبل أكثر من سبعة أعوام والذي يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن يبلغ (33) ألف طفل، يعكس واقع الانتشار الكبير للأطفال العاملين في مختلف مواقع ومكونات سوق العمل. وتشير مختلف الدراسات والتقديرات الى أن الرقم يتجاوز (50) الف طفل في سوق العمل، خاصة بعد تراجع مستويات المعيشة لغالبية الأردنيين خلال السنوات الماضية. ويعاني الأطفال العاملين نتيجة عملهم من مشاكل واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية. كذلك فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من اصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات. وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع. هذا إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير الماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب الممنهج، الأمر الذي يجعل إنتاجيتهم متدنية.
الصحة والسلامة المهنية
وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، فعلى الرغم من أن الأردن لم يصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. فإنه يمكن القول أن معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل الأردني والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي (جزئي) مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. أما على أرض الواقع فإن مستويات تمتع العاملين في الاردن بشروط الصحة والسلامة المهنية ضعيفة وهنالك غياب واضح لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشآت الأعمال في الأردن، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة. وتتعارض الأرقام الرسمية التي تتناول اصابات العمل في الأردن، ففي الوقت الذي تشير ارقام وزارة العمل الى ازدياد إجمالي حوادث واصابات العمل خلال العام 2010 الى 20 ألف إصابة عمل و100 حالة وفاة إلى جانب 1500 حالة عجز كلي، تسببت في خسارة الاقتصاد الوطني ما يقارب 80 مليون دينار اردني. تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للسنوات الست الماضية أن مؤشر اصابات العمل لكل الف عامل في تراجع مستمر، ففي الوقت الذي سجل فيه هذا المؤشر 2.5 بالأف عام 2005 فإنه تراجع الى 1.9 بالألف في عام 201، وكلا المؤشرين مرتفعين.
معايير عمل أخرى
والى جانب من تم استعراضه أعلاه، وفي ضوء التقارير الصحفية والدورية التي يقوم باعداها فريق المرصد العمالي، هنالك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في العديد من قطاعات العمل، فهنالك أعداد كبيرة يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه (استحقاق الراتب)، التي حددها قانون العمل في المادة (46) منه، كذلك هنالك قطاعات واسعة من العاملين لا يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى إجازات طارئة.
وهنالك أيضاً انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بساعات العمل، فما زال العديد من القطاعات العمالية التي يعملون ساعات تتجاوز الساعات الثمانية التي حددها قانون العمل الأردني في المادة (56) منه. هذا بالإضافة إلى غياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات الآلف العاملين بحيث يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم بدون أسباب مقنعة. اذ ما زالت المواد القانونية المتعلقة بعملية انتهاء عقد العمل وتسريح العاملين والفصل التعسفي تعاني من الكثير من القصور، فقد عانت قطاعات واسعة من العمال الأردنيين من التسهيلات التي يقدمها القانون في اطار المواد (25 و 26 و28 و31) لعمليات إنهاء خدمات العاملين، ولم يقم المشرعون الأردنيون بسد هذه الثغرة في قانون العمل والتي طالبت فيه مختلف منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وخاصة النقابات العمالية. ان بقاء هذه الثغرات في قانون العمل الأردني ستبقي الباب مفتوحاً أمام العديد من التجاوزات والانتهاكات ضد العاملين بأجر، وستبقى تهدد الاستقرار والأمن الوظيفي الى جانب العوامل المهددة الاخرى. كذلك هنالك قطاعات واسعة من العاملين لا يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى الإجازات الطارئة.
وأدى تطبيق نموذج تنموي غير عادل والذي ادى الى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية الى استمرار توسع القطاع غير المنظم (غير الرسمي)، وقد تفاقم عدد العاملين في القطاع غير المنظم مؤخرا وبلغ 44 بالمائة من مجمل العاملين. وقد تزايدت وتيرة توسع هذا القطاع بسبب تشجيع الحكومات الأردنية المتعاقبة لهذا النوع من النشاطات الاقتصادية باعتباره قطاعا لديه امكانيات كبيرة على التشغيل. ومشكلة هذا القطاع في الأردن أن غالبية العاملين فيه يفتقرون إلى الحدود الدنيا من الحقوق العمالية الأساسية، ويصنفون ضمن الفئات الأشد فقرا بين العاملين بأجر. ويلاحظ الاتساع الدائم لهذا النوع من الأعمال بسبب انتشار واتساع الفقر في الأردن وتزايد معدلات النمو السكاني، البالغة (2.2%)، إلى جانب ضعف مستوى التدريب والتأهيل للعاملين (العمالة غير الماهرة) وضعف مستوى التنمية في المناطق الريفية الأردنية، والتطورات التقنية المتسارعة التي تمكن العاملين من العمل من منازلهم.
التوصيات:
1. اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لتركز أكثر على بناء اقتصاد يولد فرص عمل ويحسن من شروط العمل، بحيث تعتمد على نموذج تنموي قائم على منهج حقوق الانسان يمكن المواطنين من التمتع بحقوقهم الانسانية الأساسية بما فيها الحق بمستوى معيشي كاف ولائق وشروط عمل مرضية وعادلة.
2. اجراء تعديل دستوري بحيث يتم الغاء ربط كفالة الدولة للحق بالعمل بإمكانياتها.
3. اعادة النظر بمستويات الأجور وحدها الأدنى لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشري الفقر والتضخم.
4. وضع حد أعلى للأجور، لأنه في ذات الوقت الذي تتدنى فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملين بأجر في الأردن، فإن هنالك مجموعة من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً مقارنة مع بقية زملائهم في العمل، الأمر الذي يزيد من مستويات التوتر الاجتماعي.
5. تعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يفتح المجال لجميع العاملين في القطاع العام (المدني) بتشكيل نقاباتهم دون قيود ووفق مبادئ حرية التنظيم النقابي، وتمكينهم من ممارسة حق المفاوضة الجماعية مع الادارات الحكومية.
6. تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
7. المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
8. زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة اعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.
9. زيادة فاعلية أنظمة التفتيش المتبعة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الأردنية.
10. تشديد الرقابة على المؤسسات للحد من تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، وتوفير بيئة عمل ملائمة للأحداث ما بين سن 16 و 18 سنة، وضبط عملية تسرب طلبة المرحلة الأساسية من المدارس قبل إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي.
11. الوقوف عند الفجوة الواضحة بين سياسات التعليم المهني والفني والأكاديمي وبين حاجات سوق العمل، لتتم عملية الربط بينهما بشكل يسهم في تخفيض مستويات البطالة.
12. توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن دون استثناء، كذلك هنالك ضرورة لشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي.
13. تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل، بما يسمح بحماية حقوق العمال.










